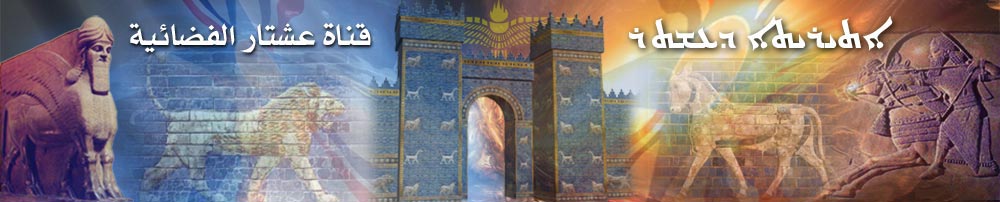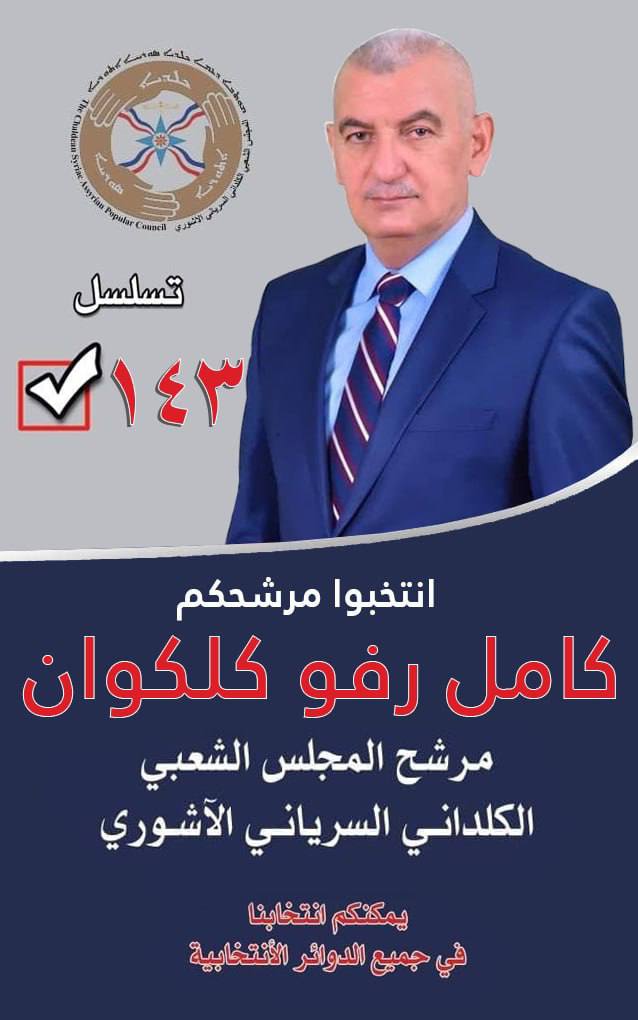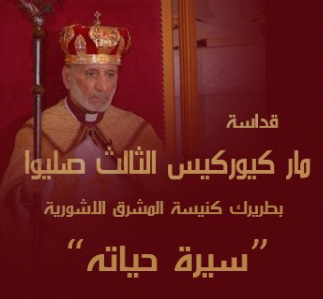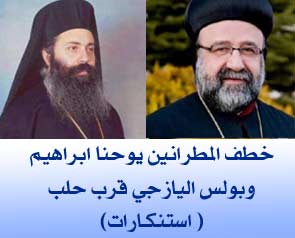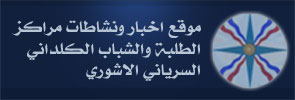إعادة تخيّل الصفحات المفقودة من التراث السرياني، حين يصبح الذكاء الاصطناعي كاتب الذاكرة

عشتار تيفي كوم - سيريك برس/
بيث نهرين – في العالم الصامت للمخطوطات السريانية، حيث لا يزال حبر القديسين والشعراء والعلماء يهمس عبر القرون، لا يُعدّ التلف مجرّد انحلال مادي، بل هو صمتٌ ثقافي. فتمزّق ورقةٍ من الرقّ أو احتراق صفحةٍ بفعل الرطوبة أو الإهمال ليس مجرد مشكلة تقنية تُقلق المختصّين بالترميم؛ بل هو، بالنسبة للشعب السرياني، محْوٌ هادئٌ لنبض حضارةٍ، وانقطاعٌ لسلسلة التواصل مع لغة المسيح، ومع تلك الحضارة السريانية التي منحت العالم أوائل جامعاته ومكتباته، وأولى ترجماته للفلسفة اليونانية، وجسوره الفكرية بين الشرق والغرب. واليوم، دخل كاتبٌ جديد إلى قاعة النسّاخين ألا وهو الذكاء الاصطناعي.
في تطوّرٍ كان يومًا من خيال العلم، بدأ باحثو الإنسانيات الرقمية السريانية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة بناء المخطوطات التالفة أو الناقصة بصريًا. فما كان يُرى سابقًا كلطخة حبرٍ غامضة أو هامشٍ متآكل، يُبعث اليوم من جديد في صورة رقمية ناصعة تُعيد للصفحة ملامحها التي سلبها الزمن والخراب. إنها ليست عملية تنظيف رقمي، بل نوع من القيامة.
من الغبار إلى النور
لطالما صارع علماء فقه اللغة هشاشةَ مصادرهم. فقرونٌ من الرطوبة والحروب والنزوح حوّلت عددًا لا يُحصى من المخطوطات السريانية إلى أشباحٍ باهتة: حبرٌ سال بين الصفحات، حروفٌ التهمتها الديدان، وفقـراتٌ ضاعت حين أُحرقت الأديرة أو نُهبت.
لأجيال، كان الترميم يعني نسخًا يدويًا صبورًا وتخميناتٍ حذرة. أما اليوم، فتستطيع النماذج التوليدية للذكاء الاصطناعي أن تأخذ النص المفرّغ (سواء كُتب يدويًا أو عبر تقنية التعرف على النصوص اليدوية HTR) وتُعيد تخيّل الصفحة كما كانت.
المنهج، الذي طُوّر في مشاريع حديثة بدعم من صندوق العلوم النمساوي (FWF) ومنصة Transkribus، يبدو بسيطًا، تُزوّد الخوارزمية بالنص السرياني الكامل، وتُحدّد نوع الخط، والتصميم الجمالي، ثم تُنتج صفحةً تُحاكي الأصل بكل دقة.
في تجربة لافتة، جرى “ترميم“ صفحة تالفة من العهد الجديد السرياني المحفوظة في المكتبة الوطنية النمساوية (ÖNB Cod. Syr. 4) عبر الذكاء الاصطناعي. وكانت النتيجة مدهشة، صفحة ناصعة أعيد بناؤها حرفًا حرفًا وسطرًا سطرًا. بل إن الباحث درّب الخوارزمية على التعرّف إلى رمزٍ ليتورجيٍّ دقيق – علامة النقاط الأربع – فظهرت في موضعها الصحيح في الهامش، كما كانت منذ قرون.
لكن وراء هذا الإعجاز الرقمي ظلّ مقلق. فالخوارزميات نفسها القادرة على إحياء صفحة إنجيلٍ مفقودة يمكن أن تُزيّف أخرى. يمكن لمزوّر أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج “اكتشافٍ جديد“ لقصاصةٍ سريانية من كتاب أخنوخ أو إنجيلٍ منحول، بملمس رقٍّ واقعي وملامح شيخوخةٍ مزيفة. وهكذا، قد تتحوّل أداة الحفظ إلى سلاحٍ ضد الحقيقة.
ولذلك، يؤكد الباحثون في الإنسانيات الرقمية على قاعدةٍ لا تقبل النقاش وبمعنى اخر الشفافية المطلقة، فيجب وسم كل صورةٍ مولّدة بالذكاء الاصطناعي بعبارةٍ واضحة ودائمة “إعادة بناء بالذكاء الاصطناعي“. فهذه ليست آثارًا أصلية، بل تصوّرات تفسيرية – أدواتٌ للخيال، لا أدلةٌ للتاريخ، بمعنى آخر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على رؤية الماضي، لكنه لا يجوز أن يخترعه.
بعدسة سريانية
وراء هذا الإبداع الرقمي المذهل يقف شيء أعمق من الخوارزميات، الذكاء البشري، فإنجازات المشاريع السريانية الرقمية لا تقوم على الأكواد وحدها، بل على عمق المعرفة اللغوية والثقافية للباحثين الذين يوجّهون التقنية.
إعادة بناء مخطوطة سريانية تتطلب أكثر من تمييز الحروف. إنها تحتاج إلى إتقانٍ لغوي لأنواع الخطوط السريانية المتعددة، وإلى ذاكرة ليتورجية تستحضر الصلوات القديمة، وإلى فهمٍ سياقي لتطوراتٍ لاهوتية وتاريخية متشابكة. فلا آلة تستطيع أن تشعر بإيقاع صلاةٍ سريانية، أو أن تلتقط الصدى الهادئ للمزمور 91 في ختام صلاة المساء.
كما يقول الباحث إفرام إسحق، المشرف على مشروع “تحديد الأجزاء المبعثرة من المخطوطات والقطع الليتورجية السريانية” (ISP) في أكاديمية العلوم النمساوية:
“إن البصيرة الإنسانية، المستندة إلى المعرفة والخبرة، تبقى ضرورية لتقدّم دراسات المخطوطات.“
إسحق، وهو سرياني (كلداني – آشوري – آرامي)، يجمع في عمله بين الدقة الأكاديمية والعاطفة الوجدانية. يسعى في بحثه إلى توحيد الشظايا الموزّعة بين مكتبات وأديرة العالم، متتبعًا جذورها في الحياة الليتورجية للكنائس السريانية. ومن خلال بناء مدوّنة رقمية للنصوص الليتورجية السريانية، يهدف مشروعه إلى ترميم ما مزّقه الزمن والحروب والتشريد.
إحدى لحظات مشروعه اللافتة كانت حين تعرّف على قصاصة سريانية في متحف تورفان بالصين، أثرٍ من رحلة المسيحية القديمة على طريق الحرير. لم يكن ذلك انتصارًا لخوارزمية، بل لذاكرةٍ بشرية؛ استدعاءٌ لإيقاع صلاةٍ مألوفة، وآيةٍ محفوظة، وصوتٍ لا يسمعه إلا القلب.
من التراث إلى الشفاء
بالنسبة للثقافة السريانية، يحمل هذا الحوار بين الإنسان والآلة معنىً خاصًا. فاللغة السريانية ليست مجرّد فضولٍ أكاديمي، بل الهوية الروحية واللغوية لشعبٍ موزّع اليوم بين العراق وسوريا وتركيا ولبنان والمهجر. كل مخطوطة – سواء كانت عظةً لمار يعقوب السروجي أو قطعةً من قداس برصليبي – هي جمرةٌ باقيةٌ من حضارةٍ أنارت الأديرة من نصيبين إلى الموصل. في هذا السياق، يغدو الذكاء الاصطناعي أكثر من أداة؛ إنه وسيلةُ شفاءٍ. فبجمعه رقميًا بين أجزاءٍ مزّقتها الحروب والاستعمار وتجارة الآثار، يقوم الباحثون بترميمٍ رمزي لتراثٍ مكسور.
وفي إحدى الحالات، أعيدت رقميًا صفحاتٌ من حلب كانت قد استُخدمت أغلفةً لمخطوطاتٍ أخرى، ففُتحت رقميًا وسُطّحت لتظهر كما كانت في الأصل. ما نراه هنا مفارقةٌ شعريةٌ عميقة: أقدمُ لغةٍ مسيحية تُحفَظ اليوم بأحدث تقنيات العقل البشري.
الذكاء الاصطناعي لم يأتِ ليحلّ محل الباحث أو الناسخ، بل ليُحاورهم، ليواصل حوارًا بين العصور. وكما حفظ النسّاخ السريان الفلسفة اليونانية بترجمتها إلى لغتهم، يحفظ الباحثون الرقميون اليوم التراث السرياني بترجمته إلى لغة البيانات.
لكن التقنية وحدها لا تكفي لصون هذا الإرث. فالمسؤولية الكبرى تقع على الإنسان: على يقظته الأخلاقية، وشفافيته العلمية، والتزامه الصادق بالحقيقة. قد يُعيد الذكاء الاصطناعي الصفحة، لكن الإنسان وحده هو من يصون روحها.
أما بالنسبة للسريان، فهذه الشاشات التي تُعيد إحياء الرقّ المفقود ليست مجرد فنٍّ رقمي، بل أعمال تذكّرٍ ومقاومة للنسيان. كل كلمة تُستعاد، وكل هامشٍ يُرمَّم، هو فعلُ تحدٍّ هادئ للزوال.
وهكذا، في ضوء شاشةٍ في فيينا أو في حولب (حلب)، تومض حروفُ إنجيلٍ مفقودٍ من جديد – ليست قديمةً تمامًا ولا جديدةً تمامًا، بل معلّقةٌ بين الأزمنة.
- 2025-11-20 شرطة الحدود السويدية: ترحيل 742 عراقياً منذ 2024
- 2025-11-20 وكالة الطاقة الذرية تلزم إيران بالكشف عن مخزون اليورانيوم.. وطهران: قرار سياسي
- 2025-11-20 أوروبا تدرب 3000 شرطي لنشرهم بغزة.. وباريس تبحث سلاح حماس
- 2025-11-20 مالية كوردستان: إيقاف رواتب غير المسجلين في مشروع "حسابي" نهاية العام الحالي
- 2025-11-19 إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان عن شهر أيلول في الحساب المصرفي للمالية العراقية
- 2025-11-19 قيادي في "الحكمة": الحكومة المقبلة لن تنتظر طويلاً.. والبيت الشيعي بدأ العدّ التنازلي
- 2025-11-19 شراكة استراتيجية بين السعودية وأميركا تشمل الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة النووية
- 2025-11-19 على غرار غزة.. خطة أميركية جديدة من 28 بنداً لإنهاء حرب أوكرانيا
- 2025-11-18 الرئيس بارزاني والسوداني يبحثان في دهوك مستقبل المرحلة السياسية وقانون الانتخابات
- 2025-11-18 ترمب "لا يستبعد" إرسال قوات إلى فنزويلا.. ومادورو: مستعد للحوار "وجهاً لوجه"
- 2025-11-18 البرلمان الأردني يقر إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي
- 2025-11-18 مسرور بارزاني يرحب باختيار أربيل كأول وجهة سياحية في آسيا عام 2026
- 2025-11-17 لمناقشة أمن الشرق الأوسط.. خبراء العالم يجتمعون في مؤتمر MEPS بـ دهوك الثلاثاء
- 2025-11-17 خزين العراق المائي يخطف ربع مليار م3 من الامطار الأخيرة.. والعشب عاد للحياة في المراعي
- 2025-11-17 واشنطن تحشد قرب فنزويلا.. أحدث حاملة طائرات تصل الكاريبي
- 2025-11-17 لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن انطلاق محاكمات المتهمين
- 2025-11-16 رئيس حكومة إقليم كوردستان يرسي حجر الأساس لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل
- 2025-11-16 بريطانيا تجري "تغييرات صارمة" على نظام قانون اللجوء
- 2025-11-16 ضربة لم تكتمل.. تقرير يكشف بقاء "قلب" نووي إيران نابضا
- 2025-11-15 مجلة Condé Nast Traveler لوجهات السفر: 2026 هو عام المسافرين إلى أربيل
- المزيد
- 2025-11-20 من الركض خلف الناخبين الى الهرب منهم
- 2025-11-20 انه المرجع وعليكم اتباع كلامه
- 2025-11-20 شرطة الحدود السويدية: ترحيل 742 عراقياً منذ 2024
- 2025-11-20 وكالة الطاقة الذرية تلزم إيران بالكشف عن مخزون اليورانيوم.. وطهران: قرار سياسي
- 2025-11-20 أوروبا تدرب 3000 شرطي لنشرهم بغزة.. وباريس تبحث سلاح حماس
- 2025-11-20 مالية كوردستان: إيقاف رواتب غير المسجلين في مشروع "حسابي" نهاية العام الحالي
- 2025-11-20 لقاح واحد يحمي النساء من السرطان ومضاعفات الحمل
- 2025-11-20 إيلون ماسك: العمل لن يكون ضرورة للبشر خلال 20 عاماً
- 2025-11-20 تقرير منظمة “عون الكنيسة المحتاجة” العالمي: العراق — حرية دينية هشة وسط نزاعات قانونية وضغوط طائفية وتهديدات داعش المستمرة
- 2025-11-20 وفد من المنظمة الآثورية يلتقي البطريرك مار أفرام الثاني كريم في دمشق